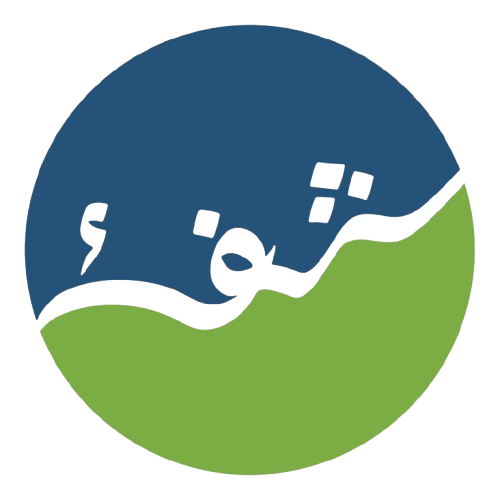في هذا المقال، سنسلّط الضوء على الاضطراب الوهامي، أنواعه، العلامات التي تستدعي الانتباه، وأفضل طرق الدعم والتعامل مع المصابين به بوعي واحترام.
ما هو الاضطراب الوهامي؟
الاضطراب الوهامي (Delusional Disorder) هو حالة نفسية نادرة تتميز بوجود أوهام ثابتة تستمر لمدة شهر على الأقل، دون ظهور أعراض ذهانية أخرى مثل الهلوسات. غالبًا ما تكون هذه الأوهام غير غريبة، أي أنها ممكنة الحدوث من الناحية الواقعية لكنها غير صحيحة، مثل الاعتقاد بأن الشخص مراقب أو مضطهد. يُلاحظ هذا الاضطراب غالبًا في منتصف إلى أواخر العمر، ويُعد أكثر شيوعًا لدى النساء مقارنة بالرجال. ورغم أن المصابين به يحتفظون بوظائفهم الاجتماعية والمعرفية في الغالب، إلا أن شدة الانشغال بالأوهام قد تصل في بعض الحالات إلى درجة تؤثر سلبًا على حياتهم اليومية وتُعطّل قدرتهم على العمل أو التفاعل الاجتماعي، مما يجعل اكتشاف الحالة وتشخيصها تحديًا حقيقيًا.
أسباب الاضطراب الوهامي
يجدر الإشارة إلى أن الباحثين لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد الأسباب الدقيقة للاضطراب الوهمي. ومع ذلك، تتجه الأنظار نحو مجموعة من العوامل التي قد تسهم في تطور الحالة، بما في ذلك:
العوامل الوراثية
تشير زيادة انتشار الاضطراب الوهمي بين الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة به أو بالفصام إلى وجود دور محتمل للعوامل الوراثية. ويُعتقد أن القابلية للإصابة بهذا الاضطراب قد تنتقل من الوالدين إلى الأبناء عبر الجينات.
العوامل البيئية
الصدمات النفسية
أظهرت الأبحاث أن التعرض للصدمات النفسية في مرحلة الطفولة مثل الإهمال العاطفي أو الإساءة الجسدية والجنسيّة, يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاضطرابات الذهانية بشكل عام، ويُظهر المصابون بتاريخ من هذه الصدمات ميلًا أكبر لحدوث أوهام وهلوسات أكثر حدة. وعلى الرغم من ندرة الدراسات المباشرة حول الاضطراب الوهمي، يُرجَّح أن العوامل نفسها تسهم في ظهوره وتفاقم أوهامه .
إدمان المخدرات
تعاطي المواد المخدرة، مثل الكحول والقنب (الحشيش)، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالذهان، وقد يكون له دور في تطور الأوهام حتى في حال عدم الوصول إلى مرحلة الإدمان. ويُعرف هذا النوع من الذهان بـ”الذهان الناتج عن تعاطي المواد” (Substance-Induced Psychosis)، وهو لا يُصنّف بالضرورة كاضطراب وهامي مستقل، بل يُعد حالة ترتبط مباشرة بتأثير المادة على الدماغ.
عوامل أخرى
تشمل عوامل الخطر الأخرى:
- التعرض لضغوط نفسية شديدة أو مستمرة.
- الإصابة بأمراض عضوية أو عصبية
- انعدام الثقة، الشك، وتدني تقدير الذات
- بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بالأوهام، مثل المهاجرين الذين يواجهون صعوبات لغوية، وذوي الإعاقات السمعية أو البصرية، وكبار السن.
أنواع الاضطراب الوهامي
تتعدد أنواع الأوهام التي قد يعاني منها المصابون باضطراب الوهم، وتشمل:
-
الوهم الاضطهادي (Persecutory type):
يشعر المريض أن هناك من يراقبه أو يحاول إيذاءه، مما يجعله سريع الانفعال، وقد يكون عدوانيًا أو حتى يلجأ إلى مقاضاة الآخرين.
-
الغيرة الوهمية (Jealous type):
الشك بالخيانه والذي يُعرف أيضًا بـ”متلازمة عطيل“، يرتبط غالبًا بالرجال وقد يترافق مع أفكار انتحارية أو ميول لايذاء الغير.
-
الوهم العاطفي (Erotomanic type):
يعتقد المريض أن شخصًا مهمًا أو ذا مكانة اجتماعية يحبّه سرًا. غالبًا ما يكون هؤلاء المرضى منعزلين، يميلون للاعتماد على الآخرين، يعانون من كبت جنسي وانخفاض في الأداء الاجتماعي والمهني، وقد يُفسّرون رفض الطرف الآخر على أنه دليل حب غير مباشر.
-
الوهم الجسدي (Somatic type):
النوع الجسدي من الأوهام يكون فيه المريض مقتنعًا تمامًا بوجود مرض أو خلل جسدي خطير، مثل الشعور بوجود طفيليات في الجسم، أو قناعة بأن رائحته كريهة جدًا رغم عدم وجود دليل على ذلك. هذا النوع غالبًا ما يكون مصحوبًا بقلق شديد وتوتر دائم.
-
جنون العظمة (Grandiose type):
يتجسد في اعتقاد المريض بأنه شخص استثنائي يمتلك قدرات أو مكانة فريدة، كأن يرى نفسه نبيًا أو زعيمًا عالميًا أو عبقريًا خارقًا، ويكون هذا الاعتقاد ثابتًا وغير قابل للتغيير.
توجد أيضًا أنواع مختلطة، حيث يعاني المريض من أكثر من وهم في الوقت ذاته، وأنواع غير محددة يصعب تصنيفها تحت فئة واحدة. من أمثلتها متلازمة كابغراس، حيث يعتقد المريض أن شخصًا قريبًا منه قد تم استبداله بشخص شبيه، أو متلازمة كوتار، التي يعتقد فيها المريض أنه فقد أعضاء من جسده أو أنه ميت بالفعل.
أعراض الاضطراب الوهامي
تختلف طبيعة الأفكار لدى المصاب بالاضطراب الوهام باختلاف نوع الوهم الذي يعاني منه، لكن فيما يلي أبرز السمات المشتركة المميزة لهذا الاضطراب:
- وجود أوهام ثابتة تستمر لمدة شهر على الأقل.
- عدم وجود أعراض ذهانية أخرى بارزة مثل الهلوسات أو اضطرابات التفكير الشديدة.
- عدم إدراك الشخص لكون معتقداته غير واقعية، وصعوبة تقبل هاته الفكرة.
- اندفاع الغضب والسلوك العدواني عند الشعور بالاضطهاد أو الشك أو الغيرة.
- الإصابة بالقلق أو الاكتئاب نتيجة الأوهام.
- الشعور المستمر بالاستغلال أو الظلم.
- يمكن استبدالها بـ: “الارتياب الزائد في نوايا المحيطين به”.
- تفسير التصرفات الحميدة على أنها تهديدات.
- الإصرار على الاحتفاظ بالأحقاد وعدم نسيان الإساءة المتصورة.
- الاستعداد المبالغ فيه للرد على الإهانات الوهمية.
تشخيص الاضطراب الوهامي
يُشخَّص الاضطراب الوهامي بناءً على المعايير المعتمدة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5) أو التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11)، مع التأكيد على ضرورة استبعاد أي اضطراب نفسي آخر أو سبب عضوي قد يكون مسؤولًا عن الأعراض. ولهذا الغرض، قد يلجأ الطبيب إلى إجراء فحوصات مثل دراسات التصوير أو تحاليل الدم. وتشمل هذه الأسباب:
- مرض ألزهايمر.
- الصرع.
- اضطراب الوسواس القهري.
- الاضطراب ثنائي القطب.
- اضطرابات الشخصية.
- الهذيان.
- اضطرابات طيف الفصام الأخرى.
- في حالات قليلة، عند الاشتباه في وجود مشكلة طبية أو عصبية، قد يُقترح إجراء اختباراتٍ مثل مخطط كهربية الدماغ (EEG) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي المحوسب (CT).
إذا لم يُعثر على أي سببٍ عضوي أو مرضٍ نفسيٍّ آخر يمكن أن يفسر الأعراض، فقد يحيل الطبيب المريض إلى طبيب نفسي (طبيب مختص بالاضطرابات الذهانية) أو اختصاصي نفسي (أخصائي علم النفس العيادي)، وهما الجهاتُ المؤهلةُ لتشخيص ومعالجة الأمراض العقلية.
يعتمد اختصاصي الصحة النفسية في تشخيصه على:
- استعمال اختبارات تقييمية خلال سلسلة من المقابلات، بهدف التقصّي عما إذا كانت الأعراض تنتمي إلى اضطراب ذهاني.
- تقييم سلوك المريض، ملاحظة مدى تأثير الأوهام على تفاعله اليومي وعلاقاته الاجتماعية والمهنية.
- سؤال أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين عن سلوك المريض وأي تغيّرات ظهرت لديه، خصوصًا إذا كان المريض يتكتم على أوهامه.
علاج الاضطراب الوهامي
يُعدّ اضطراب الوهم من الاضطرابات النفسية التي يصعب علاجها، ويُعزى ذلك غالبًا إلى إنكار المريض لوجود أي خلل نفسي.لذا يتم التعامل مع هذا الاضطراب من خلال خطة علاجية شاملة تجمع بين العلاج الدوائي، والعلاج النفسي، إضافة إلى دعم الأسرة والمجتمع.
العلاج الدوائي
يلعب علاج الاضطراب الوهامي بالأدوية دورًا مهمًا في السيطرة على شدة الأوهام وثباتهايعتمد العلاج بشكل أساسي على الأدوية المضادة للذهان، التي تعمل على إعادة التوازن للناقلات العصبية في الدماغ
تنقسم هاته الأدوية إلى نوعين رئيسيين:
1. المضادات التقليدية للذهان
تُعرف أيضًا بـ”النوروليبتيك”، وهي أدوية تُستخدم منذ خمسينيات القرن الماضي. تعمل على تقليل نشاط مادة الدوبامين في الدماغ، التي ترتبط بتكوين الأوهام. من بين هذه الأدوية:
- هالوبيريدول
- كلوربرومازين
- فلوفينازين
- بيرفينازين
2. المضادات غير التقليدية للذهان
وهي جيل أحدث يتميز بفعالية مشابهة لكن مع أعراض جانبية أقل. تعمل على تنظيم نشاط مادتي الدوبامين والسيروتونين، من أشهر هذه الأدوية:
- أريبيرازول (Abilify)
- أولانزابين (Zyprexa)
- كويتيابين (Seroquel)
- ريسبيريدون (Risperdal)
- كلوزابين (Clozaril)
وفي حالات محددة، قد يُضاف مضاد اكتئاب أو مهدئات في حالات القلق الشديد أو اضطرابات النوم بناءً على الأعراض المصاحبة.
العلاج النفسي
يلعب العلاج النفسي دورًا مكملًا هامًا للأدوية، ويرتكز على جلسات دورية تهدف إلى دعم المريض نفسيًا وتدريبه على مواجهة أفكاره.
أنواع العلاجات النفسية المفيدة:
- العلاج النفسي الفردي: يساعد المريض على فهم طبيعة أفكاره المشوهة ومحاولة تعديلها.
- العلاج المعرفي السلوكي (CBT): يُمكّن المريض من التعرف على أنماط التفكير السلبية وتغيير سلوكياته المرتبطة بها.
دور الدعم الأسري والاجتماعي
يلعب دعمُ الأسرة والمجتمع دورًا تكميليًا ومحوريًا في العلاج، لا سيّما في المراحل الأولى بعد التشخيص. من المهمّ توعية الأسرة بخصائص الأوهام والتمييزِ بين الهلوسة والأوهام. فهذا، بالإضافة إلى الدعم النفسي، يُسهم في تقليل مشاعر العزلة وتحفيز المريض على الاستمرار في العلاج.
كيفية التعامل مع مريض يعاني من الاضطراب الوهامي
التعامل مع المصاب بهذا النوع من الاضطرابات الذهانية يتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة الحالة، واتباع أساليب مدروسة تساعده على الشعور بالأمان النفسي.
ما يجب فعله
- تجنُّب الحركات المفاجئة أو الإيماءات العصبية..
- منح المصاب الوقت الكافي للتفكير قبل الرد.
- الحفاظ على مستوى النظر نفسه مع المصاب، وعدم الوقوف قائمًا فوقه إذا كان جالسًا.
- الاستعداد للاتصال بمختص نفسي أو بالطوارئ في حال ظهور علامات على خروج الوضع عن السيطرة.
- التعامل بجدية مع أي تحذير أو تهديد.
ما يجب تجنبه
- السخرية من أفكار المريض أو محاولة “إثبات” خطئه بالمنطق.
- الدخول في جدال حول صحة الأوهام أو تصحيحها بالإجبار.
- الصوت المرتفع أو حركات الجسد التي يمكن أن تفهم كتهديد (التحديق أو القرب الجسدي)
- حصر حركة المصاب.
- تجنّب الحديث المباشر عن “المرض” خاصة إذا لم يكن الشخص يعترف بوجوده، والتركيز بدلًا من ذلك على مشاعره وتجربته الذاتية عوضًا عن محاولة تصحيح “الواقع” الذي يراه.
متى تحتاج الأسرة لمساعدة متخصصة؟
يجب استشارة مختص عندما يتم ملاحظة أي من الأعراض التالية:
- ملاحظة الأوهام.
- ملاحظة تدهور وظيفي مستمر.
- ظهور سلوك عدواني أو ميول للعنف
- ملاحظة ميول للعزلة المفرطة.
اقرأ أيضا : متلازمة جوسكا: الأسباب، الأعراض وطرق العلاج المتاحة
أسئلة شائعة قد تهمك
هل يمكن التعافي التام من الاضطراب الوهامي؟
في بعض الحالات، ولا سيما عند التدخل المبكر والالتزام بالعلاج، قد يصل بعض المرضى إلى حالة من التعافي التام، غير أن ذلك يظل احتمالًا نادر الحدوث نسبيًا.
هل الاضطراب الوهامي مرض مزمن؟
يُصنف الاضطراب الوهمي كمرض مزمن، إلا أنَّ العلاج السليم يمكّن أغلب المصابين من التخفيف من أعراضهم. يستعيد بعض الأفراد تعافيهم التام، بينما قد يمر آخرون بفترات تنشط فيها المعتقدات الوهمية تليها فترات هدوء وانقطاع للأعراض.
هل يشكل خطرًا على الآخرين؟
عادة لا يُشكل المريض خطرًا واضحًا على الآخرين، إلا في حال وجود وهام اضطهادي يسبب شعور قوي بالتآمر عليه من قبل المحيطين.
على الرغم من أن بدايات الاضطراب الوهامي قد تبدو خفيفة أو غير ملحوظة، فإن تجاهل الأوهام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات في العلاقات الاجتماعية والحياة المهنية. يتطلّب العلاج مقاربة متكاملة تجمع بين الأدوية المضادة للذهان، وجلسات العلاج النفسي، إضافة إلى دور الأسرة في توفير بيئة آمنة وداعمة تساعد المصاب على استعادة توازنه. ونظرًا لتنوّع طبيعة الأوهام، من الضروري التمييز بينها وبين الهلوسات أو اضطرابات مثل الفصام، لتفادي التشخيص الخاطئ وتأخير العلاج المناسب. إذا لاحظت ظهور أي من هذه العلامات لدى أحد المقرّبين، وتبحث عن استشارة طبية موثوقة، يمكنك زيارة موقع DocDialy.com للاطّلاع على خيارات الرعاية المتاحة.